أخبارثقافة عالمية
أمين الزاوي وجرأة اقتحام المربّعات الخطرة

من أكثر الكُتّاب الجزائريين والمغاربة إشعالاً لنار الأسئلة المسكوت عنها، وكأنّ الروائي الجزائري أمين الزاوي، كان يقصد مساره الأدبي والفكري لاحقاً، حين كتب أولى مجموعاته القصصية، في الحي الجامعي بوهران عام 1978، واختار لها عنواناً “ويجيئ الموج امتداداً”.
لم يتوقّف الزاوي (1956) عن الكتابة بالعربية، ثم بالفرنسية، على مدار نصف قرن، كما لم يتوقّف عن الترجمة والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والفعاليات الأدبية، ضيفاً ومضيفاً.
إثارة الجدل
ما بين روايته الأولى “صهيل الجسد” عام 1982، والأخيرة “الأصنام: قابيل الذي رقّ قلبه لهابيل” (2023)، لم تخلُ أعماله التي قاربت العشرين، ممّا يثير الجدل في الواقع والمواقع.
وإذا أضفنا إليها مقالاته وتصريحاته الصحافية، حتى وهو يدير المكتبة الوطنية الجزائرية، بين عامي 2002 و2008، حيث أقيل بسبب محاضرة جريئة لأدونيس، احتضنتها المكتبة الوطنية، يمكن القول إن صاحب رواية “يصحو الحرير”، من أكثر الكُتّاب الجزائريين والمغاربيين جرأة في الطرح.
عبور الأجيال
في لقائه مع “الشرق”، ينفي الزاوي “أن تكون هناك أجيال في الكتابة، على غرار لاعبي كرة القدم، الذين يرفعون راية الاستسلام لوهن الجسد، أما في الإبداع فهناك الكتابة وحدها التي تبقى، وهناك الكاتب المسكون بالتاريخ في حركيته، وبتفاصيل المجتمع، يراقب بعيون لا تنام، وبلغة وأسلوب متجدّدين”.
يقول الزاوي: “كلما كتبت نصّاً أشعر كأني أعيش دهشة الكتابة، كما في أوّل قصة لي كتبتها وأنا تلميذ في الثانوية”.
ويؤكد قناعته “بأن “الجيلية” كذبة في الأدب. فقط هناك مدارس واتجاهات، وهناك كاتب جيّد وآخر متوسط وكاتب عادي. وهناك شيوخ من الكُتّاب في عمر العشرين، وشباب في السبعين”.
حزب الكتابة
سألناه: يبدو أنك تؤمن بمراجعة الخيارات، فما علاقة الزاوي اليساري في بدايته بزاوي اليوم فكرياً؟
أجاب:”لم أخن الكاتب فيّ يوماً، جئت الكتابة في فترة كان فيها صوت اليسار في الثقافة والأدب هو الصوت العالي والطاغي، وكانت الماركسية تجربة على الكاتب الشاب أن يمرّ بها إجبارياً، مع أني لم أنخرط في حزب سياسي أبداً”.
يضيف: “كنت في عيون الموجة السياسية في تلك المرحلة، نهاية سبعينات القرن العشرين، الكاتب الليبرالي المتحرّر، وكان ذلك عيباً بل تهمة ضدّ الكاتب، أو مشروع الكاتب”.

تابع: “ربما هذه الحرية التي انتميت إليها مبكراً، هي التي جعلتني أواصل مشروعي في الكتابة مستقلاً، وأخوض من خلالها كثيراً من المشاق والأتعاب. أنا كاتب ضدّ المؤسسة وضدّ التحزّب”.
وعن تحوّله إلى الكتابة بالفرنسية بدءاً بروايته “الخنوع” عام 2007، وإذا ما كانت مراجعة شكلية على مستوى اللغة أم عميقة على مستوى المخيال، يقول: “إن مراوحتي بين الكتابة بالعربية وبالفرنسية، تشعرني بأني أعبّر أحسن تعبير عن المجتمع الثقافي الجزائري، المختلف تماماً عن المجتمعات العربية والمغاربية الأخرى”.
تمايز جزائري
يشرح صاحب مذكرة “النخب الثقافية في الفضاء المغاربي” فكرته بالقول: “لدينا نحن الجزائريين تجربة تاريخية متكاملة سياسياً وثقافياً ولغوياً، تختلف عن تجارب الشعوب ونخبها في البلدان العربية الأخرى”.
حظ لغوي
يواصل محدّث “الشرق”: “أكتب بالعربية، وأشعر براحة وأنا أتعامل معها من دون أية عقد تجاهها، من حيث أنني أتقنها ودرست بها، وأدّعي أنني مطّلع على متونها الثقافية والأدبية التراثية والمعاصرة الكبرى”.
يضيف: “علاقتي مع العربية تختلف عن علاقة جيل الخمسينات من الكُتّاب باللغة الفرنسية، من أمثال محمد ديب وآسيا جبار وكاتب ياسين ومولود معمري وجان سيناك وجون عمروش ومولود فرعون. هؤلاء لم يكونوا يعرفون العربية، ولم يكونوا قادرين على القراءة أو الكتابة بها”.
أطير بجناحين
يرى الزاوي أنه يمارس الكتابة باللغة الفرنسية كمستعمر لها، فهو لا يعتبرها “غنيمة حرب” كما قال كاتب ياسين، لأنه من جيل غير جيله، ولا يعتبرها “منفى” كما عبّر عن حاله تجاهها مالك حداد.
يقول: “أنا من خرّيجي المدرسة الجزائرية، قبل التعريب التام، حيث اللغة الفرنسية مستعمرتي الثقافية، استوطنتها بكل ارتياح، ولم أدخلها مجبراً أو هارباً من العربية، وخلال أربعة عقود أكتب باللغتين، وأصدر تقريباً كل سنتين رواية بالعربية وأخرى بالفرنسية، فأشعر بأني أطير بجناحين يمنحاني التوازن”.
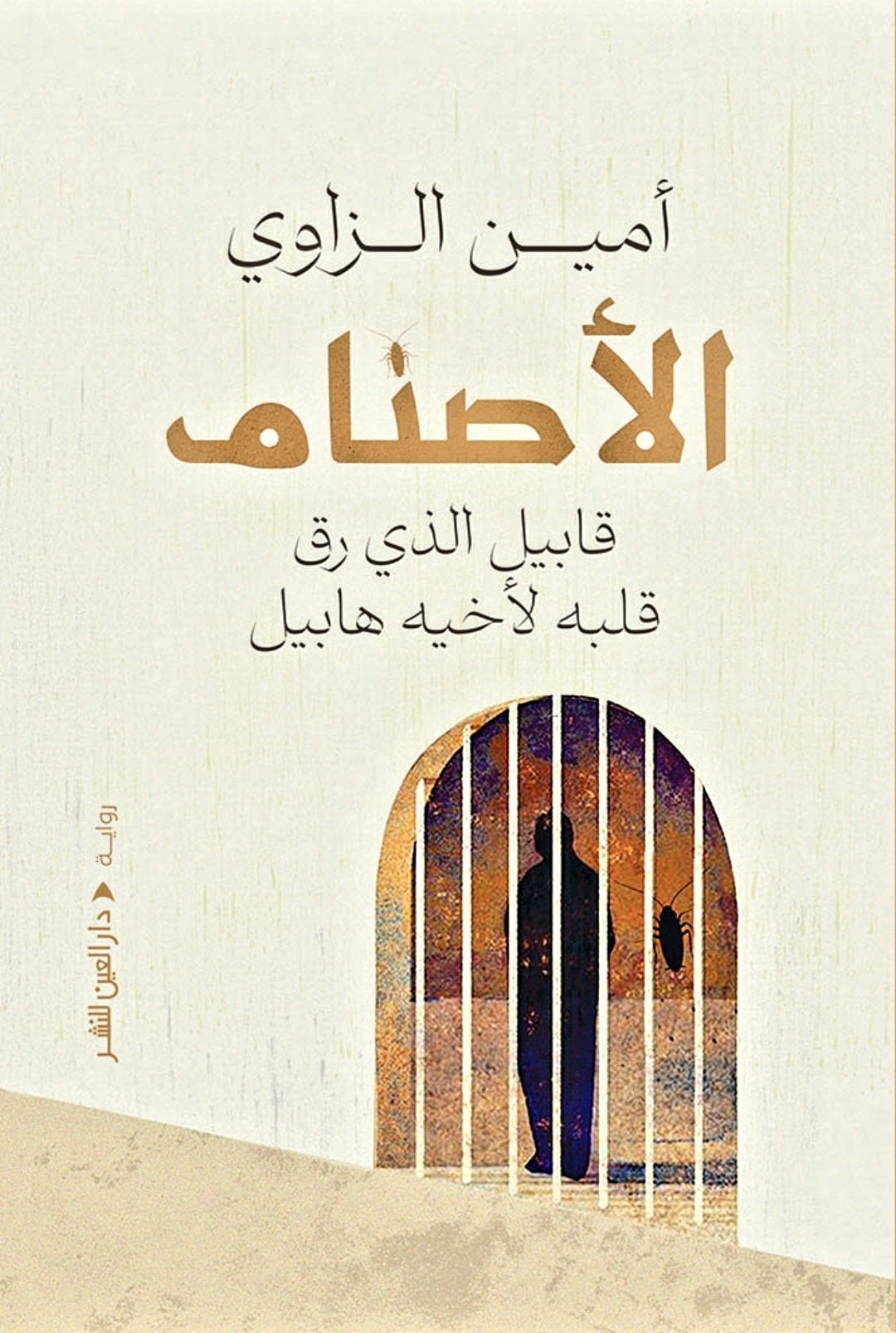
“المفرنس والمعرّب”
ومثلما أصرّ محدّثنا على أن الفرنسية تحظى بمقروئية أوسع من العربية في الجزائر، يصرّ على أن القارئ الجزائري المفرنس، أكثر تحرّراً من نظيره المعرّب، بالنظر إلى الحمولة الفكرية لكل سياق ثقافي.
لكن صاحب البرنامج التلفزيوني “أقواس”، تدارك بالقول إنه يشعر “بأن قارئ العربية، مع توسّع استعمال وسائل التواصل، بدأ يتحرّر من قيوده الأيديولوجية شيئاً فشيئاً، وبات يرى في معارض الكتب قارئاً بالعربية للرواية بشكل خاص، مع تراجع ملحوظ في الإقبال على ما أسماه “الكتاب الديني الأيديولوجي المتطرّف أو الشعبوي”.
سلطة الجامعة
ويرجع صاحب رواية “شوينغوم” ما أسماه “التكلّس القرائي”، إلى كون “الجامعة الجزائرية لعبت دوراً كبيراً في إبعاد القارئ المعرّب عن النصوص الجيّدة بالعربية، من خلال ما يُقدّم من أطروحات جامعية في الأدب الجزائري المعاصر، وتكريس صورة “الخيانة” لديه عن الكُتّاب الذين يكتبون بالفرنسية، وخصوصاً منهم الأسماء الجديدة”.
هنا سألنا الزاوي عن حدود جرأة الكاتب على الموروث، فقال: “إنه لا سقف للحرية في الكتابة الأدبية، فالأدب، هو توأم الحرية، وإذا ما غابت الحرية سيولد النص ميتاً، أو يحمل بذرة موته فيه. إن الكتابة تنمو في حقل الحرية وتدافع عنها”.
الكاتب الموهبة
وشدّد على “أن الكاتب لا ينبغي أن يكتب في أمور يجهلها، فهو يؤمن بانتهاء عصر الكاتب “الموهبة”، وانبثاق عصر الكاتب المعرفة، إذ على الأديب روائياً كان أم شاعراً، أن يتسلّح بالفلسفة والتاريخ واللسانيات وما جاورها من المعارف الأخرى”.
ويعتبر أن “التكنولوجيا أتاحت للكاتب المجتهد، إمكانية الاطلاع على ما يحتاجه وما يطلبه بشكل منهجي وسريع في مختلف الميادين. فقط عليه أن يكون مالكاً لفضول المعرفة وجرأة اقتحام المربعات الخطرة.”
الكتابة والدي
حاولنا أن نقترب من مفهوم صاحب رواية “الباش كاتب” للمربّعات الخطرة في الكتابة الأدببة، بسؤاله عن مدى حق الكاتب الجريء في أن يصدم محيطه، فقال: “إن الأدب بالأساس قائم على الصدمات التي تجعل القارئ يعيد النظر في كثير من أفكاره وقناعاته، التي يعتقد أنها تبقى لزمن طويل مسلّمات سماوية. النص الذي لا يحرّك السؤال في القارئ يحمل موته في عنقه”.
أسلاف أحياء
برهن الزاوي على ما ذهب إليه، في هذا الباب بالقول: “إن كل الذين زُندقوا في التراث العربي الإسلامي من الكُتّاب والفلاسفة والفقهاء والمتصوّفة، في زمنهم، هم الذين يفتخر بهم العرب اليوم، ويعتبرون أنهم قدّموا للبشرية نوراً وتنويراً، مثل ابن الراوندي والفارابي والمعرّي والجاحظ وبشار بن برد وابن سينا وابن رشد وأبي نواس وابن حزم والحلاج وابن عربي.
وهل يرى الزاوي أن تحوّلات وسائط التلقّي الجديدة ستفرز أدباً جديداً، وهل لديه استعداد لأن يكتبه؟ يجيب: “إن الكتابة بأجناسها الأدبية مقبلة على تجارب جديدة، من خلال تدخّل المنتوج التكنولوجي المدوٍّخ، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، لذا علينا الاستعداد ككُتّاب لمثل هذا التغيير”.
رواية الرومانس
من هنا، لا يخفي صاحب رواية “الملكة”، كونه يراقب فلسفياً ما يُكتب فيما يسمّى “رواية الرومانس” في أوروبا وأميركا، وما يعرفه هذا الجنس الهجين من إقبال كبير من قبل القرّاء من الجيل الصاعد، ومن جهات العالم الأربعة.
يقول: “علينا أن لا نتيبّس في مواقعنا، بل على الروائي أن يكون مستعداً للمغامرة في كل لحظة، بشرط أن تكون هذه المغامرة الأدبية قائمة على قراءة وتمعّن وتأمّل”.
الوطن المقيم
لا يجد الزاوي حرجاً في القول: “لا يعجبني الكاتب الذي يفتخر بأنه لا يعرف تشغيل برمجيات هاتفه الذكي، أو جهاز الحاسوب الجديد، أعتبر ذلك تخلّفاً”.
كان سؤالنا الأخير للكاتب: “يتوقّع من يقرأك ولا يعرفك أن تكون مقيماً بالضرورة في الفضاء الغربي، بالنظر إلى توفّر الحريات، وقد يندهش حين يعلم أنك مقيم في الفضاء الجزائري، فيردّ:
“أقيم في بلادي الجزائر وأكتب منها، أسافر كثيراً وأعود إليها في كلّ مرة بلهفة كبرى. تنازلت عن عروض مغرية في الخارج لارتباطي بالجزائر”.
يتابع: “جميع رواياتي وكتبي النقدية والفكرية منشورة في الجزائر، ولم يتم منع أي عنوان من قِبل الأنظمة المتعاقبة، وكان النظام السياسي في الجزائر أرحمَ عليّ من القارئ، وكان ولا يزال أكثر انفتاحاً وقبولاً للاختلاف من القارئ نفسه”.
المصدر : الشرق للاخبار

